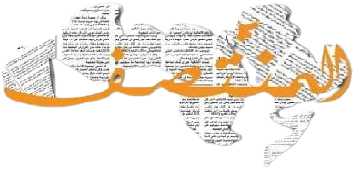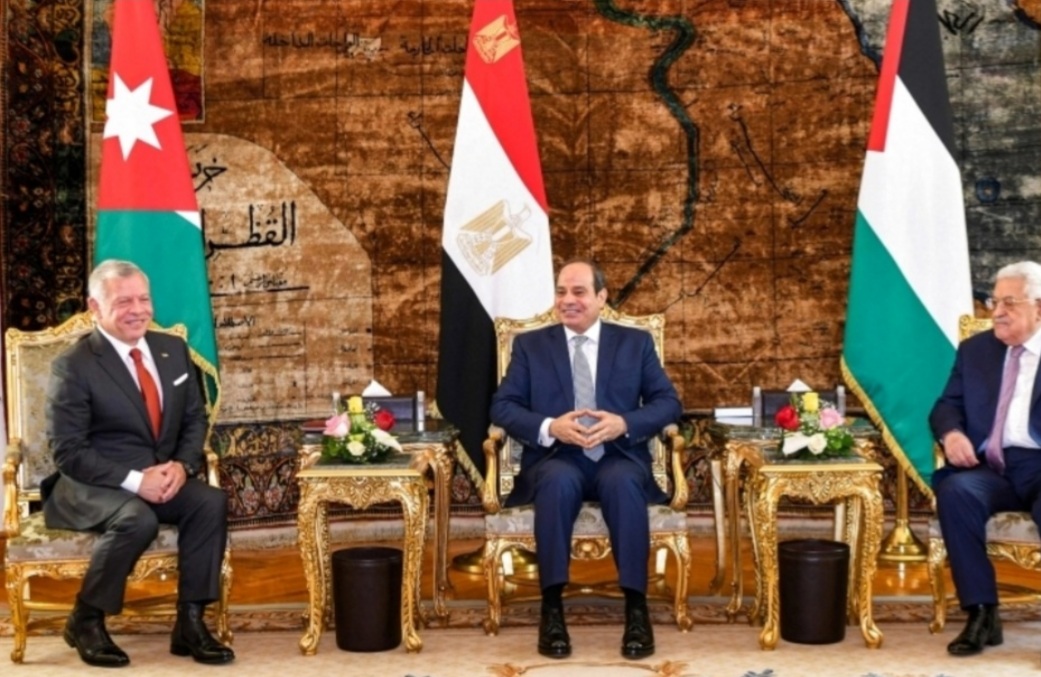الجامعات .. ضحية أم جاني؟… بقلم سعيد المومني
الجامعات .. ضحية أم جاني؟

صحيفة المنتصف
لم تعد المشاجرات في الجامعات الأردنية حدثاً طارئاً، بل أصبحت جزءاً من المشهد العام، تتكرر كما لو أنها طقس من طقوس العام الدراسي. مرة في الأردنية، ومرة في اليرموك، وثالثة في مؤتة، ثم يُقال كالمعتاد إنّ التحقيق جارٍ وإنّ الطلبة الموقوفين أحيلوا للجان الانضباط أو للقضاء، ثم يُطوى الملف بانتظار الجولة التالية. لكن ما يجري أبعد من مجرد اشتباك بين طلاب. إنه تعبير عن أزمة مركبة تمتد من بنية المجتمع إلى المدرسة، ومن غياب السياسة إلى غياب المعنى، ومن تآكل الهوية الوطنية إلى فقدان الهوية الجامعية نفسها.
في ظاهر الأمر، تبدو المشاجرات نتيجة انفعالات لحظية أو “خلافات شخصية”، لكن في عمقها هي انعكاس لواقع اجتماعي هش، يحمل كل طالب معه إلى الجامعة هويته الأولى: العشيرة، المنطقة، الأصل، الطبقة. يدخل الطالب إلى الحرم الجامعي ولا يخلع عنه جلد المكان الذي جاء منه، بل يجرّه معه إلى القاعة، فيتحول الاختلاف الأكاديمي إلى تنازع اجتماعي. والجامعة، التي كان يُفترض أن تصهر هذه الانتماءات في هوية مدنية أوسع، أصبحت ساحة لتجدّدها.
غياب السياسة هنا لعب الدور الأكبر. فمنذ أن أُغلقت أبواب العمل الحزبي داخل الجامعات، لم يعد للطلبة إطار فكري أو تنظيمي يجمعهم على فكرة أو رؤية. كانت السياسة تُعلم الشباب كيف يختلفون بالفكر لا بالأيدي، وكيف يتحاورون من خلال البرامج لا الانتماءات. وعندما تم تجريف المجال السياسي، لم يعد أمامهم سوى أن يعودوا إلى أصولهم الأولى بحثاً عن معنى للانتماء. وحين تُغيب الدولة الهويات الفكرية والسياسية، تملأ الفراغ الهويات الاجتماعية. فالمجتمع الذي يُمنع فيه المواطن من المشاركة في الشأن العام، يُعيد إنتاج القبيلة كبديل عن الفكرة.
الأزمة لا تبدأ في الجامعة، بل قبلها بسنوات طويلة، في المدرسة التي ما عادت تربي على التفكير أو الحوار. فالطالب يُدرّب منذ طفولته على التلقي لا على السؤال، على الطاعة لا على النقد، وعلى الخوف من الخطأ بدل الشجاعة في الاختلاف. ومع كل مرحلة تعليمية يفقد جزءاً من حسّه المدني، حتى يصل إلى الجامعة كجسم أكاديمي دون وعي اجتماعي.
المجتمع نفسه لم يكن بعيداً عن هذه المعادلة، ما زال يعيش بنية ديمغرافية متجاورة أكثر منها مندمجة. الشمال غير الجنوب، والشرق غير الوسط، والأردني من أصل فلسطيني غير الأردني من أصل شركسي أو شامي. كل هذه التقسيمات حاضرة في المخيال الاجتماعي، تتعايش لكنها لا تندمج تماماً. والجامعة، بدل أن تكون مساحة تذويب لهذه الفروقات، تحولت إلى نسخة مكبّرة من الشارع. وهكذا لم تعد المشاجرة الجامعية مجرّد خطأ فردي، بل مرآة لتناقضات بنيوية في المجتمع نفسه.
وللإنصاف، لا يمكن اختزال المشكلة في “العشيرة” كما يحلو للبعض. فالعشيرة في جوهرها بنية اجتماعية وأخلاقية أسهمت في بناء الدولة، وقدمت التضامن والانتماء قبل وجود المؤسسات الحديثة. لكن حين تتراجع الدولة في أدوارها، وتضعف المدرسة في التربية، وتغيب السياسة عن الفضاء العام، فإن العشيرة تعود لتملأ الفراغ بوظيفتها القديمة، لا لأنها اختارت ذلك، بل لأن الدولة تركت لها المساحة. هنا تكمن المفارقة، لسنا ضد العشيرة، بل ضد تحولها من شبكة تضامن إلى أداة صراع.
اللافت أن معظم هذه المشاجرات تقع في الجامعات الحكومية لا الخاصة. ليس لأن طلابها أكثر عنفاً، بل لأن بيئتها أكثر ازدحاماً وأشد هشاشة. في الجامعات الخاصة يدفع الطالب كلفة تعليمه، فيحرص على وقته ومستقبله، بينما في الحكومية يشعر بأنه نال مقعده بالاستحقاق أو المكرمة، فتضعف مسؤوليته الفردية لصالح الانتماء الجمعي. ثم إن الجامعات الخاصة تُدار بعقل إداري تجاري صارم، بينما تغرق الحكومية في البيروقراطية وضعف الإدارة. لذلك تصبح الأخيرة أكثر عرضة لتفجر الهويات الخام فيها، لأن الطالب فيها يعيش شعوراً بالضيق والانتظار لا بالانتماء والفرص.
الجامعة في الأصل ليست فقط مكاناً لتلقّي العلوم، بل فضاء لصناعة الإنسان، وإنتاج وعي جماعي، وتشكيل عقل نقدي مستقل. غير أن هذا الدور تراجع لصالح وظيفة أخرى أكثر ضيقاً، أن تكون محطة لعبور اقتصادي واجتماعي. لم تعد الجامعات الأردنية تحمل هويات فكرية أو معرفية واضحة، بل تحولت إلى تصنيفات طبقية. أي جامعة يختارها الطالب لم تعد تُعبّر عن توجهه الفكري، بل عن قدرته المادية أو موقعه الاجتماعي. أصبح “نوع الجامعة” يرمز إلى الطبقة لا إلى الفكرة. وهذه مفارقة خطيرة، فبينما تحمل الجامعات في العالم هويات فكرية، منها ما يُعرف بتوجهه اليساري أو الليبرالي أو المحافظ، اختفت الهوية الفكرية في جامعاتنا لتحل محلها هوية السوق.
حين تغيب الفكرة، تُختزل الجامعة إلى مؤسسة خدماتية تمنح شهادة، لا مشروعاً للتفكير. ولهذا تتلاشى فيها روح الانتماء الأكاديمي، فلا الطالب يرى نفسه جزءاً من مجتمع معرفي، ولا الأستاذ يشعر أنه يبني عقلاً جديداً. كل شيء محكوم بالبيروقراطية والدرجات والتمويل والوجاهة. المعرفة فقدت معناها، والتعليم فقد رسالته، والجامعة فقدت هويتها. صارت ممراً إلى الوظيفة، إن وُجدت، لا إلى الوعي.
تتحمل الدولة بدورها القسط الأكبر من المسؤولية. فهي التي نزعت السياسة من التعليم، وضيّقت على العمل الطلابي، وأضعفت الاتحادات الجامعية، وحولت الجامعة إلى جهاز إداري خاضع للرقابة والخوف. كما أنها لم تخلق بيئة اقتصادية تمنح الشباب أفقاً حقيقياً، فصارت الجامعة محطة انتظار في طابور البطالة، لا جسراً إلى المستقبل. في مثل هذا الفراغ، يصبح الاحتقان هو القاعدة، والعنف هو اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى إذن.
المشاجرات الجامعية إذن ليست أحداثاً عابرة تُعالج بقرارات انضباطية، بل هي مؤشّر على خلل عميق في بناء الدولة والمجتمع معاً. علاجها لا يكون بالشرطة داخل الحرم، بل بإعادة المعنى إلى الجامعة. بإحياء السياسة لا خنقها، بإصلاح التعليم لا تجميله، وبإعادة الاعتبار لقيمة الفكر على حساب قيمة الورقة. المطلوب ليس جامعة بلا مشاجرات، بل جامعة تملك هوية فكرية ومدنية تحميها من أن تتحول إلى ساحة صراع لهويات بلا معنى. فحين تستعيد الجامعة وظيفتها الأصلية، سيتعلم الطالب أن يرفع صوته بالحجة لا باليد، وأن الانتماء الحقيقي ليس للعشيرة ولا للمنطقة، بل لفكرة الدولة التي ما زلنا نبحث عنها في كل مشاجرة جديدة.